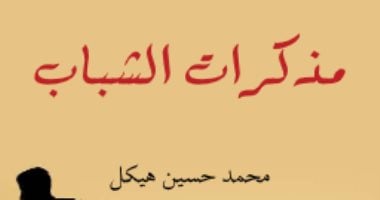نواصل التعرف على مشروع الكاتب العربى الكبير عباس محمود العقاد (1889 -1964) الذى قدم فكرا تنويريا وأعاد قراءت التراث والواقع العربي، ونتوقف اليوم مع كتابه "أنا".
يقول عباس محمود العقاد فى الكتاب تحت عنوان " مكان التواضع واللين".
إننى لا أزعم أننى مفرط فى التواضع.
ولكننى أعلم علم اليقين أننى لم أعامل إنسانًا قط معاملة صغيرٍ أو حقير، إلا أن يكون ذلك جزاء له على سوء أدب.
وأعلم علم اليقين أننى أمقت الغطرسة على خلق الله، ولهذا أحارب كل دكتاتور بما أستطيع، ولو لم تكن بينى وبينه صلة مكان أو زمان، كما حاربت هتلر ونابليون وآخرين.
وأنا لا أزعم أننى مفرط فى الرقة واللين.
ولكننى أعلم علم اليقين أننى أجازف بحياتى، ولا أصبر على منظر مؤلم أو على شكاية ضعيف.
فعندما كنت فى سجن مصر رجوت الطبيب أن يختار لى وقتًا للرياضة غير الوقت الذى تُنصَب فيه آلة الجلد لعقوبة المسجونين.
فدُهِش الطبيب، ظن أنه يسمع نادرة من نوادر الأعاجيب …
وقال لى فى صراحة: ما كنت أتخيل أن أسمع مثل هذه الطلب من العقاد "الجبار".
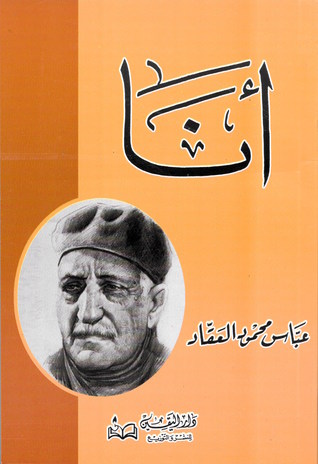
وأُصِبت فى السجن بنزلة حنجرية حادة حرمتنى النوم وسلبتنى الراحة، ولم تزل هذه النزلة الحنجرية عندى مقدمة لأخطر الأمراض كما حدث قبل نيف وعشرين سنة، ونجوت منها يومئذ بمعجزة من معجزات العلاج والعناية وتبديل الهواء، ومن أجل هذه النزلة الحنجرية ألبس فى الشتاء تلك الكوفية التى علقتها الصحف الفكاهية فى رقبتى لا تحل عنها فى صيف أو شتاء، ولا فى صبح أو مساء، حتى أوشكت أن تكون من علامات تحقيق الشخصية قبل الملامح والأعضاء.
وكانت زنزانة السجن التى اعتُقِلت بها على مقربة من أحواض الماء، شديدة الرطوبة والبرودة، يحيط بها الأسفلت من أسفلها إلى أعلاها، ولا تدخلها الشمس إلا بإشارة من بعيد.
فعرض المحامون أمرى على المحكمة وحوَّلته المحكمة إلى النيابة، ودرسته النيابة مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون، وتقرر بعد البحث الطويل نقلى إلى المستشفى، وإقامتى هناك فى غرفة عالية تشرف على ميدان واسع وحديقة فسيحة، وتتصل بالداخلين والخارجين أثناء النهار، ويتردد عليها الأطباء والموكلون بالخدمة الطبية من الصباح إلى الصباح.
فرج من الله، وأمنية عسيرة التحقيق تمهدت بعد جهد جهيد!
فصعدت إلى المستشفى وأنا أعتقد أن الخطر الأكبر قد زال أو هان، ولكنى لم ألبث هناك ساعة حتى شعرت أن الزنزانة المغلقة أهون ألف مرة من هذا المكان الذى أصغى فيه إلى أنين المرضى، وشكاية المصابين والموجعين، ثم غالبت نفسى ساعة فساعة، حتى بلغت الطاقة مداها ولما يطلع الفجر من الليلة الأولى، وإذا بى أنهض من سريرى وأنادى حارس الليل ليوقظ ضابط السجن ويعود بى إلى الزنزانة من حيث أتيت، ولتفعل النزلة الحنجرية وعواقبها الوخيمة ما بدا لها أن تفعل.
أنا أعلم من نفسى هذا، وأعلم أن الرحمة المفرطة باب من أبواب العذاب فى حياتى منذ النشأة الأولى، وأعلم ما أعلم عن تلك العواطف التى يتحدث بها بعض الفضوليين ولا يعرفون منها غير التصنع والتمثيل، وتدميع العيون، وتبليل المناديل، ثم أسمع جبلًا من هذه الجبال البشرية يذكر الرحمة وما إليها، كأنها حلية لا يزين الله بها إلا أمثاله، ولا يعطل الله منها إلا أمثال عباس العقاد … فماذا يكون حكمى بعد هذا على آراء الناس فى الناس؟!
لن يكون إلا قلة اعتداد برأى من الآراء يحسبونها الكبرياء وليست هى الكبرياء، ولكنها موقف من لا يبالى أن يعتقد من يشاء ما يشاء.